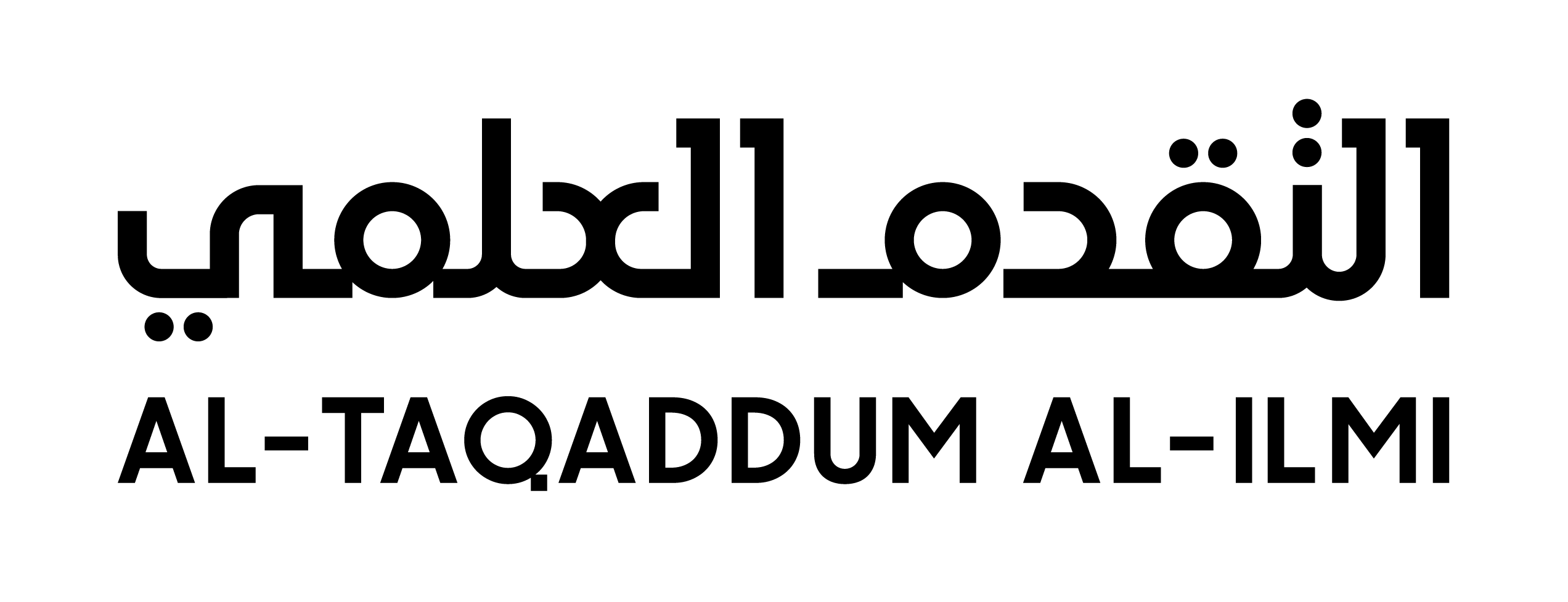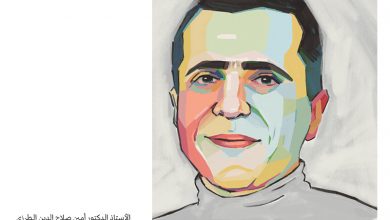لماذا لا تنتشر الثقافة العلمية في مجتمعاتنا ؟

د. عبدالله الجسمي
على الرغم من مرور أكثر من قرن على دخول التعليم الحديث إلى مجتمعاتنا العربية وانتشاره بشكل واسع في العقود الأخيرة، والدخول في عدة أوجه من تحديث البنى التحتية في معظم الأقطار العربية، يضاهي بعضها أحدث النماذج المدنية في العالم، فإن ذلك لم يفتح المجال لتغلغل الثقافة العلمية في مجتمعاتنا لتقودنا إلى الدخول الحقيقي في روح العصر وثقافته. فهناك بلا شك عقبات عدة تعترض انتشار الثقافة العلمية، منها ما هو ثقافي واجتماعي وسياسي وفكري. فما أهم العقبات التي تقف أو تحد من نشر الثقافة العلمية؟
الأساس الذي تقوم ُعليه الثقافة
هنالك قضية جوهرية تتعلق بالأساس الذي تقوم عليه الثقافة في أي مجتمع، والذي يكون مسؤولاً عن تشكيل قيمها وممارساتها وإبداعاتها وطرق تفكيرها وغيرها من مكونات الثقافة الأخرى. فالثقافة مثلاً في الدول الصناعية والمتقدمة تعتمد على العلم الذي تعامل من خلاله الإنسان مع الواقع المادي، فالحضارة المدنية الحديثة التي بدأت في أوروبا منذ عصر النهضة تقوم على أساس علمي ومادي، ساهم بصورة كبيرة في إحداث تغييرات نوعية في الثقافة الأوروبية ولاحقاً الإنسانية. في المقابل نجد ثقافتنا أو ثقافاتنا الدارجة تعتمد بالدرجة الأولى على أسس اجتماعية وتؤدي فيها الذات دوراً مركزياً. وهذه الثقافات هي في الأغلب نتاج لعلاقات التجمعات البشرية التقليدية مع الطبيعة التي لا تزال الكثير من قيمها فاعلة على الرغم من عملية التحديث المادية التي جرت منذ عدة عقود. فقد وقف الجانب الاجتماعي كعائق حقيقي أمام التحديث الثقافي لكون الشرائح الاجتماعية تتحكم فيها منظومة محكمة من القيم المسلم بها وغير القابلة للنقاش ويتم توارثها عبر الأجيال منذ عدة قرون، وبعضها- من دون مبالغة- لآلاف السنين كالثقافة القبلية أو الثقافات العرقية. وتتميز هذه الشرائح بقوة الروابط الاجتماعية وخضوع الفرد لسلطة الجماعة وغياب الرأي المعارض أو أي نوع من النقد لأي قيمة أو قيم في إطار هذه المنظومة، إضافة إلى كونها تمثل هوية هذه الجماعة ومن ثم تؤطر كيانها الاجتماعي، وبناء عليه يكون من الصعب اختراق أو استبدال هذه المنظومة بثقافة أو هوية بديلة لأن الفرد والجماعة سيتغيرون جذرياً وستضمحل الجماعة أمام قيم ثقافية بديلة جاءت مع التطور العلمي تعزز من دور الفرد واستقلاليته.
أما العنصر الثاني وهو الذات، فتتخلل جوانب كثيرة من ثقافاتنا الدارجة وهي نتاج للعنصر الاجتماعي. فالمعايير التي تقاس بها الأشياء والمواقف والأحكام وغيرها تأخذ الطابع الذاتي، فهي لا تعتمد على الأدلة أو البراهين التي تدعمها، كما هو الحال في العلم، وتفتقر إلى الموضوعية والنظرة أو التحليل المتجرد للأمور. وقد ألقى البعد الذاتي بظله على مسألتين مضادتين للعلم؛ تتعلق الأولى بكيفية الوصول إلى المعرفة وحقائقها. فالمعرفة العلمية تتراكم أو يتم الوصول إليها من خلال المنهج العلمي، أي إنها معرفة منهجية ومستقلة عن الإنسان ولا يستطيع التحكم في نتائجها حسب آرائه الذاتية أو معتقداته. في المقابل نجد أن المعرفة الذاتية غير منهجية وهي تعتمد على الحدس وفي أحسن الأحوال نتاج للاستنباط العقلي المجرد لا التجربة. والمسألة الثانية تتعلق بطبيعة اليقين الذي يتصف في العلم بالموضوعية ويستند إلى أدلة غير ذاتية، في المقابل نجد أن اليقين الذاتي يفتقر إلى الأدلة والبراهين الموضوعية ومعاييره ذاتية وحقائقه غير قابلة للفحص أو النقد من خلال التجربة العلمية. ونتج عن ذلك أن أصبحت الثقافة شخصانية الطابع وأخذت الجوانب الشخصية تتغلغل في شتى مجالات الحياة والمجتمع وتعد أساساً للتعامل مع الآخرين والواقع، بعبارة أخرى تم شخصنة الثقافة والنظر إلى كل شيء من منظور شخصي، وهذا ما يتناقض مع الثقافة العلمية التي تتجرد من الجوانب الشخصية والذاتية.
معرفة بديلة عن العلم
أحد الإشكاليات الفعلية التي تقف حجرة عثرة أمام انتشار المعرفة والثقافة العلمية في مجتمعاتنا، تتلخص في وجود معرفة بديلة للمعرفة العلمية الحديثة تحل محلها في مختلف المجالات تقريباً. فالعلم الحديث، الذي شق طريقه منذ نهايات العصور الوسطى في أوروبا، قدم معرفة نوعية مختلفة عن المعرفة السابقة عليه، تعتمد على أسس جديدة من التفسير للوجود والظواهر والمشكلات المختلفة ومحاولة إيجاد الحلول التي تعتمد على أسس واقعية وموضوعية ممكنة التطبيق. ومع تقدم العلم وتقنياته المختلفة أزاح بشكل شبه كامل طابع المعرفة القديمة ومقوماتها التي كانت تعتمد عليها، وشكل رؤية للعالم الذي نعيشه مخالفة بشكل كبير للرؤية السابقة. لكن لم تستطع المعرفة العلمية التغلغل في مجتمعنا وتفكير أفراده بشكل كاف نتيجة لوجود معرفة بديلة عن العلم تسود بين أوساط العامة ويطرحها أفراد لا علاقة لهم بالعلم الحديث ومناهجه وأساليبه المعرفية. ولهذه المعرفة تفسيراتها الخاصة التي تقدم رؤية شمولية لتفسير العالم من جهة وواقع الإنسان ومجتمعه وما يجري به من جهة أخرى. وتتميز بالسهولة في التفسير والتحليل والاستيعاب ولا تحتاج إلى أبحاث وتجارب، وتتميز بإطارها ذي البعد الواحد، وتختفي عنها التعددية والتنوع في طرح الموضوعات ومناقشتها وتفسيرها، بل وتقصي أي تفسير أو رأي آخر مختلف عنها. فهي حبلى بالمسلمات غير القابلة للنقاش أو حتى النظر إليها من منظور عقلاني مختلف، يستخدم فيه العقل والمنهجية القائمة على الحجج والبراهين المنطقية ولا يقبل القائمون عليها تجديدها وفق المعايير المعاصرة.
وما يدعم هذه المعرفة طابع الثقافات المنتشرة في المجتمع العربي وطبيعة العادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بها، وطرق التفكير السائدة فيها، التي تستوعب تلك المعرفة الداعمة لروحها المحافظة التقليدية، وتختلف عن طرق التفكير الحديثة التي جاء بها العلم.
نشر الثقافة العلمية
نشر الثقافة العلمية يقتضي طريقة تفكير معينة تمثل الأرضية التي تستوعبها وتطبقها في مجالاتها الخاصة ألا وهي طريقة التفكير العلمي، وهذا ما لم تحققه عملية التعليم أيضاً. وللأسف تفتقر الساحة الثقافية إلى الطريقة العلمية في التحليل إلا من نفر قليل يسبح ضد التيار العام الممتلىء بأنماط من التفكير لا علاقة لها بروح العصر، فهناك من لا يزال يفكر بطريقة أقرب إلى الخرافة والأسطورة، ويهيمن التفكير الغائي، الذي يفسر الواقع والعالم وما يجري فيه بطريقة غائية على تفكير معظم الأشخاص في العالم العربي الذين لم يجعلوا للعلم أي هامش بسيط من تفكيرهم. والميزة التي تنفرد بها طريقة التفكير العلمي هي أنها واقعية وتبحث في الأسباب المادية الحقيقية التي تسبب الظواهر، وتقدم تفسيرات فعلية للظواهر والمشكلات مبنية على أدلة وبراهين وتتصف بالاتساق المنطقي والموضوعي والدقة والوضوح. أما طرق التفكير الأخرى فهي غير واقعية وتضع الأسباب خارج الظواهر الطبيعية والمشكلات، وتقدم تفسيرات ذاتية لا تعتمد على التجربة والبرهان، وهي نتاج لواقع لا دور يذكر للعلم في تشكيله أو صياغة معرفته ومناهجه. فهناك إذًا تصادم بين طريقة تفكير واقعية لها معرفتها وممارساتها وقيمها وأخرى غير واقعية تعكس قيما وتفسيرات غير واقعية. وللأسف تتغلب طرق التفكير غير الواقعية حتى هذه اللحظة على طرق التفكير العلمية والعقلانية بسبب انتشار الثقافات التقليدية والتمسك بها.
بيد أن الإشكالية الكبرى في التعليم والنظرة للعلم بشكل عام تتعلق بالتعامل العكسي مع العلم وثقافته؛ إذ بدلاً من أن يؤدي العلم وعملية التعليم دوراً مهماً في إحداث التغيير الثقافي بالمجتمع فقد حدث العكس، إذ تم تطويع التعليم والعلم وإلباسهما ثوب القيم الثقافية الدارجة في المجتمع. فالتعامل مع العلم أصبح أولاً انتقائياً، بمعنى أخذ ما يناسب القيم الثقافية والتوجهات الفكرية السائدة واستبعاد ما يتعارض معها، وثانياً توظيف العلم ونظرياته وحقائقه في الإطار الثقافي العام السائد لتعزيز وتثبيت التوجهات الفكرية والقيم والمفاهيم الثقافية الدارجة. وللأسف نجد الكثير من القائمين على التدريس خصوصاً في المستويات الجامعية يقودون هذه العملية ويروجون لذلك، وللتوفيق في أحسن الأحوال بين العلم وما هو سائد من أفكار في المجتمع. وهذا عكس ما هو مطلوب منهم كنخبة أو نخب أكاديمية تعمل على توعية المجتمع بمخزونها العلمي والأكاديمي وتسعى إلى إحداث نقلة ثقافية وفكرية نوعية فيه. وهناك بالطبع جهود يبذلها نفر من الأكاديميين الذين يسعون لتطوير المجتمع ثقافياً وفكرياً، لكنهم للأسف أقلية ونتائج جهودهم ضئيلة مقارنة بالسواد الأعظم من الفئة المناقضة لهم.
مجتمعات غير منتجة
المجتمع العربي للأسف غير منتج ولا يأخذ بالأساليب الصناعية المتطورة خصوصاً الصناعات الثقيلة منها التي تعد الركيزة الأساسية للتطور الصناعي المستند إلى العلم. فمنذ انطلاقة الثورة الصناعية الأولى أصبح العلم مقترناً بالتقدم الصناعي والاقتصادي للدول، وكل ثورة علمية منذ ذلك التاريخ تلقي بظلالها على طبيعة الإنتاج الصناعي ومن ثم على الأوضاع الاقتصادية. فالعالم اليوم يعيش الثورة الرابعة التي تقودها التكنولوجيا والتي تحدث تحولات صناعية واقتصادية عدة وستنعكس بلا شك على الثقافة والفكر. والتغيير الاقتصادي يقترن معه تغيير ثقافي حسب البيئة الاقتصادية أو الطبقية التي يعيش فيها الأفراد. وقد شهد الوطن العربي في بدايات القرن العشرين بوادر اهتمام بعدد من الصناعات التي لو استمرت لغيرت من الواقع الاقتصادي العربي، لكن للأسف تم تصفية معظم هذه الصناعات في النصف الثاني من القرن لأسباب سياسية ولم يحدث تحول اقتصادي يذكر في الدول العربية، اللهم إلا من بعض الصناعات المرتبطة بالبترول. وفي غياب التطور الاقتصادي يصعب إحداث تطور ثقافي وفكري، فالتطور الذي جرى في العالم العربي مشوّه؛ فقد تم بشكل سريع ولم يمر بالمراحل المتدرجة، ومن ثم لم يتم التخلص من المفاهيم والقيم الثقافية التي لا تتناسب مع التطور الذي ما لبث أن توقف وانحصر في البنية التحتية فقط.
والمعرفة العلمية اليوم مرتبطة إلى حد كبير بالإنتاج الاقتصادي، والمجتمعات غير المنتجة، كمجتمعاتنا، لا يمكن أن تنتج المعرفة وتؤسس لها، ومن ثم لن يكون للعلم دور فعلي في المجتمع وثقافته. فلقد أصبحنا مستوردين لمعظم ما نستخدمه في حياتنا اليومية ونستورد العلم والمعرفة ( المناهج العلمية ) أيضاً من الخارج، وحتى ما نستورده من أدوات وآلات تكنولوجية وعلمية للأسف لا يتم استخدامها وفق الأصول التي أنتجت من أجلها، بل تم تطويعها حسب الثقافات الدارجة وتوظيفها من قبل العديد من الأطراف التي لا تقيم للعالم والحضارة المدنية أي وزن. وأي مجتمع غير منتج سيكون مستهلكا وهذ ينتج عنه عامل ثقافي يعيق انتشار الثقافة العلمية وهو الثقافة الاستهلاكية. فالمجتمع الذي لا ينتج حاجياته يعيش على الاستهلاك وتنتشر فيه ثقافة استهلاكية غير منتجة لا تساعد على البحث أو الابتكار وتحمل مشقة إجراء التجارب والاختراعات وغيرها من أمور تخص البحث العلمي، وسيخلق عقلية غير نقدية لا تقوى على تحليل الظواهر والمشكلات وتبحث عن أسهل الحلول والتفسيرات التي يغلب عليها الطابع الذاتي وتتعارض مع الموضوعية المستمدة من المعرفة العلمية.
إن التغييرات التي جرت في الواقع الثقافي العربي خلال العقود الأخيرة تعتبر شكلية ولم تمس جوهر الثقافة أو الثقافات الدارجة في المجتمع، بسبب تسييس العلم وأدلجة الثقافة والجمود الفكري والقوى المحافظة التقليدية التي ترفض فكرة التقدم والتجديد وهيمنتها على العديد من مفاصل المجتمع خصوصا التعليم، وإذا ظلت هذه العوائق قائمة وغاب دور العلم الفعلي في بناء المجتمع المادي والصناعي والثقافي فستتسع أكثر وأكثر الهوة بيننا وبين ما يجري في العالم من تطورات معرفية وثقافية، وسنبقى نعيش في عالم آخر مختلف عن العالم الحقيقي.