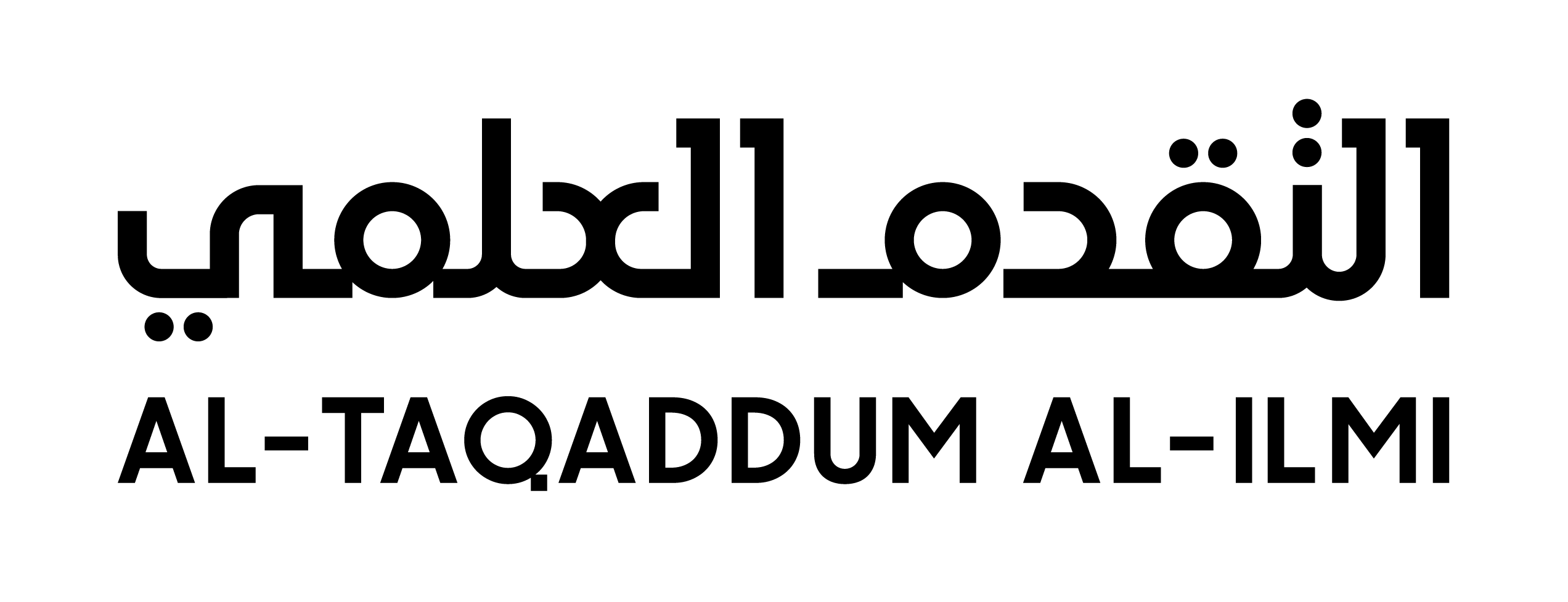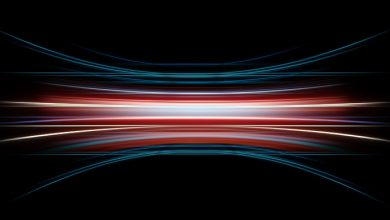د. فادي مرقص
تفترض إحدى أكثر النظريات المقبولة على نطاق واسع عن نشأة الحياة على سطح الأرض أن الحياة ولدت في المحيطات ثم شقت طريقها إلى اليابسة؛ إذ إن المحيطات كانت تزدهر بالتنوع البيولوجي قبل أن تظهر أي علامة للحياة على اليابسة. ووفقا لعدد كبير من الأدلة العلمية التي نشرتها مجلات مرموقة، فإن حيوان التيكتاليك Tiktaalik، وهو من الأنواع الانتقالية بين الأسماك وفصيلة رباعيات الأطراف (حيوانات رباعية الأرجل)، كان من أوائل الكائنات الحية التي زحفت خارج المحيط إلى اليابسة، مستخدمًا أطرافه الأربعة للسير على سطح الأرض. ويعتقد أن التيكتاليك ربما يكون سلفًا لمعظم البرمائيات والزواحف التي تجول كوكبنا حاليا. ولطالما سعت الحياة على الأرض إلى عبور حدودها التقليدية والتوسع في بيئات جديدة.
ثمة شيء نعلمه يقينًا، وهو أن الطبيعة أدت دورًا رئيسيًا في تطور الأنواع على الأرض؛ فالطبيعة بشكل غير مباشر تملي علينا الاختلافات البيولوجية والسلوكية الأكثر ملاءمة، للبقاء على قيد الحياة في مختلف البيئات والحقب الزمنية. والكائنات التي فشلت في التأقلم مع تحديات الطبيعة توجد فقط في سجلنا الأحفوري؛ في حين أن تلك التي تمكنت من التكيف مع ظروف الطبيعة القاسية، ازدهرت واستمرت سلالتها في التطور على كوكب الأرض.
الطبيعة والجنس البشري
إن التحديات التي تواجه كوكبنا لا تقل في صعوبتها عن تلك التي واجهت من سبقنا. فعلى سبيل المثال، تشكل كل من ظاهرة الاحتباس الحراري، وذوبان الجليد القطبي، تهديدًا كبيرًا لكل المدن الساحلية. وإذا ما استمر سلوكنا البيئي في النهج نفسه، فإن الخطر سيطول المدن الداخلية عما قريب.
على صعيد آخر، تشكل الكويكبات تهديدًا كبيرًا البشرية، وأشكال الحياة الأخرى على الأرض. ووفقًا للمرصد الوطني لعلم الفلك البصري- The National Optical Astronomy Observatory، فإنه في عام 2028 سيمر الكويكب 1997FX11 قريبًا جدًا من سطح كوكبنا، غير أنه سيعبر بسلام من دون أن يصطدم بالأرض. لكن إذا تغير شيء ما وحدث أن اتجه نحونا، فإننا سنكون على موعد مع كويكب يبلغ عرضه ميلا، وينطلق بسرعة 50 ألف كيلومتر في الساعة، ليصطدم بكوكب الأرض. ومثل هذا الاصطدام سيولد طاقة هائلة تعادل تقريبًا قنبلة بحجم مليون ميغاطن، وهي كافية لأن تتسبب في انقراض معظم أشكال الحياة على سطح الأرض، بما في ذلك الحياة البشرية. بيد أن هذا السيناريو ليس جديدًا على كوكبنا، حيث يُعتقد أن اصطدام نيزك بسطح الأرض قبل 66 مليون عام تسبب في انقراض الديناصورات وإبادة %70 من الحياة البيولوجية على سطح الكوكب. ومثل هذه التهديدات الوجودية وغيرها الكثير تعد بمثابة ناقوس خطر يستدعي من البشر توسيع مداركهم، وتسخير قوتهم المعرفية والتكنولوجية من أجل أن يتمكنوا من زراعة بذرة للبشرية خارج الأرض.
والحياة على الأرض ليست سهلة الاستنساخ؛ فلقد استغرق كوكبنا قرابة أربعة بلايين سنة ليصل إلى التعقيد البيئي والبيولوجي الذي نشهده حاليا. ومع ذلك، فإن البدء ببيئة ناضجة، وبمساعدة التكنولوجيا البشرية، يمكننا من استنساخ الظروف الأساسية والضرورية لدعم الحياة خارج كوكبنا. وعلى الرغم من الأمور المتداولة في وسائل الإعلام عن توسيع نطاق الحياة، لتمتد إلى الكواكب الخارجية التي اكتشفت مؤخرا في مجرتنا، فإن الحل الأكثر واقعية هو أن نجد البيئة الواعدة داخل نظامنا الشمسي.
الكواكب الُمؤهلة للحياة
هناك عدة شروط يجب استيفاؤها لدى أي جرم سماوي لتوفير بيئة صالحة لنشأة الحياة على سطحه؛ ثلاثة من أبرز هذه الشروط هي: وجود غلاف جوي، ومجال مغناطيسي، وامتلاك القدر المناسب من قوة الجاذبية. والغلاف الجوي لكوكبنا يحمينا من الإشعاعات الشمسية والكونية الضارة، ولولا طبقة الأوزون التي تمتص الأشعة فوق البنفسجية الضارة لما ازدهرت الحياة على سطح الأرض. إضافة إلى ذلك، فإن الغلاف الجوي يحافظ على درجة حرارة ثابتة، فلا نجد تباينا كبيرا بين درجات الحرارة في النهار عن الليل، أما غيابه فسيجعل درجة الحرارة في النهار تتعدى 120 درجة سيليزية وتقل في الليل لتصل إلى 170 درجة سيليزية تحت الصفر، مما قد يجعل الحياة على الأرض أمرًا مستحيلًا.
ويعتبر المجال المغناطيسي درعًا واقيًا للكوكب؛ حيث يحجز الإشعاعات الضارة المحملة بالجسيمات المشحونة، ويمنعها من الوصول إلى سطح الكوكب، مما يساعد أيضًا على الحفاظ على الغلاف الجوي، وحمايته من التآكل عند تفاعله مع هذه الجسيمات القادمة من الشمس، أو النجوم المجاورة.
وأخيرًا، فإن مقدار الجاذبية التي يمتلكها كوكب ما، يحدد بشكل كبير إمكانية وجود الحياة على سطحه من عدمها. فكما هو معلوم من قانون الجذب العام -الذي وضعه نيوتن- فإن قوى الجذب تتناسب تناسبًا طرديًا مع كتلة الكوكب، مما يعني أنه كلما زاد ثقل الكوكب زادت قوة جاذبيته. وفي حالة الكواكب الصغيرة، مثل: كوكب عطارد، فإن صغر حجمه يؤدي إلى قلة جاذبيته، التي بدورها تمنعه من الحفاظ على غلافه الجوي لفترة طويلة. فلو لم نمتلك جاذبيتنا الأرضية لكنا فقدنا أيضا غلافنا الجوي منذ زمن طويل. لكن من ناحية أخرى، إذا كان كوكبنا أثقل بكثير مما هو عليه، فإنه كان سيمتلك مقدارا أكبر من الجاذبية، كما هو الحال على كوكب المشتري العملاق، فيتكون من حوله غلاف جوي سميك، محولًا الكوكب إلى كتلة غازية هائلة من دون سطح صلب لتقوم الحياة عليه، لذا يُعتبر الكوكب المتوسط الحجم -أي ما يقدر بثلث إلى عشرة أضعاف حجم كوكب الأرض- هو المناسب لنشأة الحياة على سطحه.
آمال الكوكب الأحمر
على الرغم من أن كوكب المريخ يقع بعيدا إلى حد ما عن كوكب الأرض، حيث تستغرق الرحلة إليه ما بين 6 و 8 أشهر، مقارنة بالقمر الذي تستغرق الرحلة إليه نحو ثلاثة أيام، فإنه لا يزال يعتبر الوجهة الأقرب والأكثر جدوى لإقامة مستوطنة بشرية بعيداً عن كوكب الأرض. ويمتلك الكوكب الأحمر جاذبية بمقدار %40 من جاذبية الأرض، ما يجعله مناسباً للحفاظ على غلافه الجوي، والإبقاء على مياهه في حالة سائلة. ومع أنه يبدو لنا حاليا كصحراء حمراء واسعة، فإن هناك العديد من الدلائل العلمية القوية التي تؤكد أنه في مرحلة ما من الماضي السحيق كان عامرًا بالمحيطات والبحيرات والأنهار، مثلما هو الحال الآن على كوكب الأرض.
وقبل أن نعيد بناء الغلاف الجوي، علينا أن نمنعه من النضوب. وكما ذكرنا آنفا فإن المجال المغناطيسي هو المسؤول عن حماية الأرض وغلافها الجوي من الإشعاعات الشمسية والكونية. ونظرًا لأن المجال المغناطيسي للمريخ غير قادر على حماية غلافه الجوي، فقد اقترحت وكالة (ناسا) وضع درع مغناطيسي ثنائي القطب Dipole Magnet في نقطة “لاغرانج إل1- L1 Lagrange” المريخية، وهو ما سيمكن من تشكيل غلاف مغناطيسي اصطناعي يحيط الكوكب بكامله، ومن ثم يحميه من الجسيمات المشحونة، والرياح الشمسية والكونية.
وحاليا، تؤدي الانفجارات البركانية على سطح المريخ دورا مهما في زيادة سمك غلافه الجوي بغازات الدفيئة مثل الهيدروكربونات، لكن سرعان ما يتم فقدانها. ولكن مع وضع مغناطيس ثنائي القطب قرب مدار المريخ، سيعمل الكوكب طبيعيًا على زيادة محتويات غلافه الجوي، وهو ما سيرفع متوسط درجة حرارة الكوكب نحو أربع درجات سيليزية، وهي الدرجة الكافية لإذابة جليد ثاني أكسيد الكربون الموجود في الأغطية القطبية الشمالية للكوكب. وهذا من شأنه أن يتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري، التي سترفع بدورها درجة حرارة الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى ذوبان المياه المتجمدة في الأغطية القطبية الجنوبية للكوكب. وحينما تطأ قدما الإنسان على هذا الكوكب، يمكن استخراج غازات الكلوروفلوروكربون التي هي إحدى مجموعات غازات الدفيئة، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
البكتيريا الزرقاء
أما أصعب التحديات التي ستواجه مهمة استيطان المريخ فهو رفع مستوى الأكسجين على الكوكب. سيحتاج المريخ إلى خطة مشابهة للتي مر بها كوكب الأرض في بداية نشأته، والتي رفعت مستوى الأكسجين عليه من 1% في بداياته إلى %21 حاليا.
مع تتبع الخطوات نفسها التي مرت بها الأرض، يمكننا استخدام البكتيريا الزرقاء سيانو بكتيريا Cyanobacteria لتكسير مركبات النيتروجين في تربة المريخ، واستخدام عمليات البناء الضوئي لإنتاج الأكسجين، وإطلاقه في طبقات الغلاف الجوي. وقد استغرق هذا الأمر مئات الملايين من السنين حتى وصل كوكبنا إلى هذا المستوى المرتفع من الأكسجين، لكن يعتقد العلماء أن استخدام أنواع البكتيريا المعدلة جينيًا، يمكن أن يختصر الكثير من هذا الجدول الزمني. وأحد الحلول الواعدة الأخرى هو إنتاج الأكسجين الجزيئي O2، عن طريق انشقاق ثاني أكسيد الكربون باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، أو التحليل الكهربائي. وهذه التجربة ستختبر لإنتاج الأكسجين الجزيئي على سطح المريخ من غلافه الجوي، عن طريق المركبة الفضائية «موكسي» MOXIE، المقرر إطلاقها في شهر يوليو 2020.
زراعة البذرة الأولى للبشرية
كما هو حال جميع الأنواع الأخرى على كوكب الأرض، فإن البشرية ليست بمنأى عن خطر التعرض للانقراض. وهناك فئة قليلة جدًا من الكائنات التي سكنت كوكب الأرض، استطاعت التغلب على تحديات الطبيعة، وكانت قادرة على التكيف لفترات طويلة عبر التاريخ البيولوجي لكوكبنا؛ في حين فشلت معظم الكائنات في مقاومة هذه التحديات. وما يميز الجنس البشري هو امتلاكنا القدرة المعرفية للوصول إلى تقدم تكنولوجي غير مسبوق، يسمح لنا بتشكيل مستقبلنا؛ لذا علينا أن نستخدم هذه القوة، ونكرس جهودنا لزرع بذرة جديدة للبشرية في الفضاء، وإعادة أمجادنا السابقة حينما نزحنا من إفريقيا واستوطنا بقية القارات السبع، لكن هذه المرة، لنغادر كوكبنا في رحلة البحث عن مستقبل جديد.
إن الأرض والمريخ يشبهان توأمين شقيقين غير متماثلين، نما كل منهما بعيدًا عن الآخر ببطء بمرور الوقت. يعتقد العلماء أنه لولا فقدان المريخ مجاله المغناطيسي قبل ثلاثة بلايين عام، لكان من الممكن أن يكون موطنًا لتنوع بيولوجي معقد آخر، يشبه مثيله على الأرض. ونمتلك حاليا التكنولوجيا اللازمة لتحويل المريخ إلى ما كان عليه في الماضي، ليصبح زرع بذرة للحياة على ظهر الكوكب الأحمر مسعىً وجوديًا للبشرية.